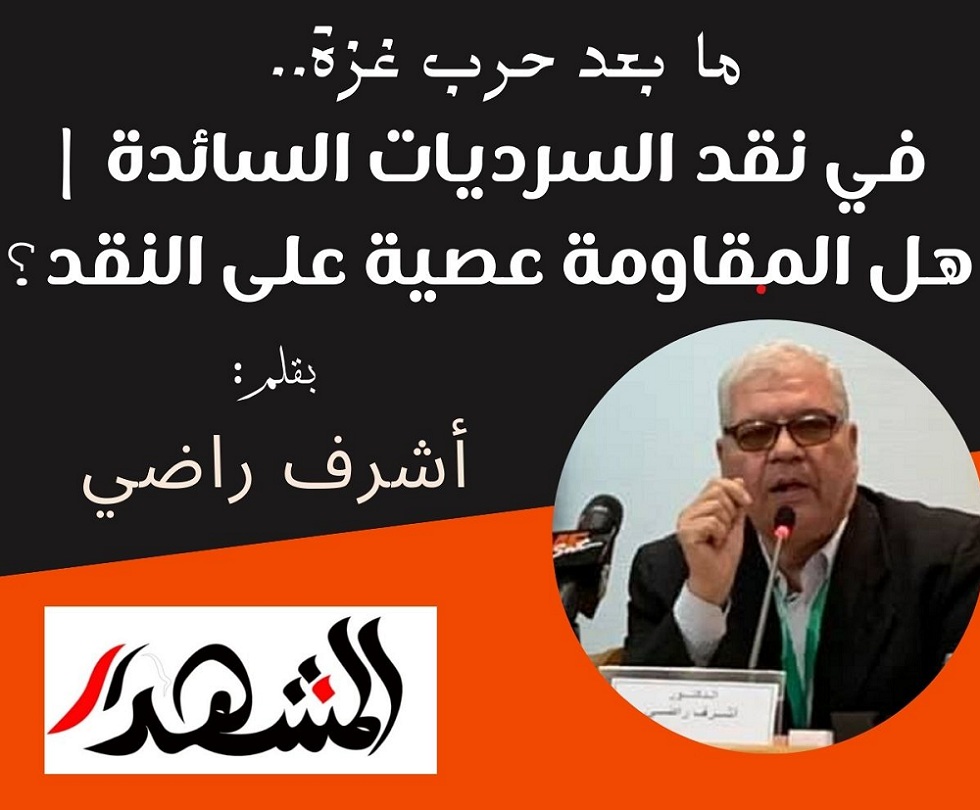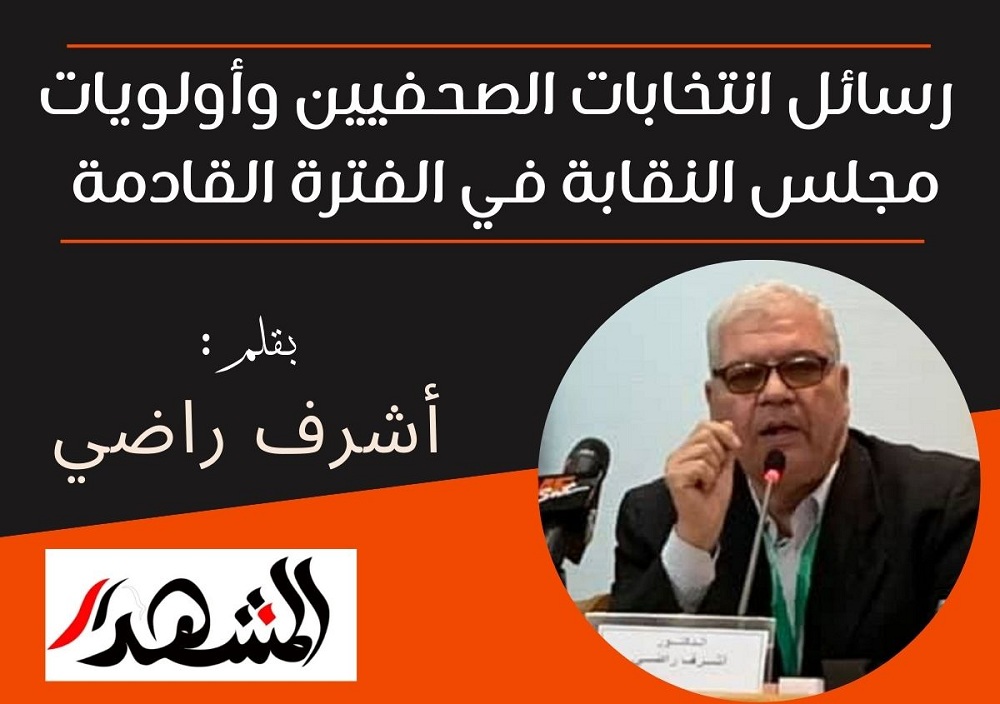حضرت مناقشة على قدر كبير من الأهمية لكتاب الدكتور عبد العليم محمد، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية بمؤسسة الأهرام، وهو خبير في الصراع العربي الإسرائيلي لا يشق له غبار. الكتاب بعنوان "القضية الفلسطينية: من صفقة القرن إلى طوفان الأقصى"، وقد نوه المؤلف في كلمته في ختام الندوة إلى أن الفكرة الأساسية التي أراد تسليط الضوء عليها في قراءته لحركة التحرر الوطني الفلسطينية وللخطاب الداعم لها على المستوى العربي، هو نقد ذلك الفصل المتعسف بين المقاومة المسلحة وبين الكفاح السياسي والسلمي، الذي لا يجد مثيلا له في تجارب حركات التحرر الوطني الأخرى في العالم، والتي زاوجت بين النهجين. هذه الفكرة تتفق مع الفكرة التي لطالما دافعت عنها في سلسلة المقالات التي كتبتها على موقع المشهد عن حرب غزة، من أجل إعادة صياغة مشروع التحرر الوطني الفلسطيني والعربي، والتي تدعو إلى حوار يفضي إلى مصالحة تاريخية بين محور المقاومة الذي يضم فصائل للمقاومة وبين نهج الإدارة السياسية والدبلوماسية للصراع التاريخي، الذي تتبناه بعض الأطراف العربية والفلسطينية. هذه المصالحة شرط أساسي، في تقديري، لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية بين السلطة وبين حركة حماس التي تتزعم المقاومة، وأن عملية الإقصاء والنفي المتبادل والاتهامات المتبادلة سوى على المستوى الفلسطيني أو على مستوى المشهد العربي العام، لا تفيد الفلسطينيين وقضيتهم العادلة، وإنما يجري استغلالها لإحكام الحصار على الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، إذا تعذر تصفية الشعب ذاته.
لم تلق هذه الفكرة الأساسية قبولاً، على ما يبدو، إلا من قبل عدد قليل من الحضور، الذي غلب عليه المنتمون إلى تيار اليسار القومي والعروبي والإسلامي، وعليه فإن هذا النقاش الذي فجره صدور الكتاب عن مركز الحضارة العربية للتنمية الثقافية، وهو من دور النشر المتميزة والملتزمة، ويشجعني على هذا النقاش ما لمسته من بارقة أمل في وجدتها في أفكار جديدة طرحها منتمون إلى هذا التيار، وهي أفكار يمكن الاشتباك معها لتطوير مشروع فكري لنقد السرديات السائدة للصراع، أراه ضرورياً من أجل إدارتنا المستقبلية، بعيداً عن الشعارات وعن الأحلام البعيدة أو تصورات للكيفية التي سيتم من خلالها حل هذا الصراع التاريخي. لقد كتبت في بداية حرب غزة 2023، أنها ليست كغيرها من حروب نشبت في القطاع الذي أصبح مركزاً للمقاومة المسلحة للعدو الإسرائيلي ورفض مشروعات التسوية السياسية وفي مقدمتها مشروع أوسلو، وتستدعي بالتالي إعادة نظر في كثير من الرؤى والتصورات والسرديات السائدة والمرتبطة بهذا الصراع.
الكتاب مرجع مهم لاستناده إلى قاعدة قوية من البيانات وقراءة دقيقة للتفاصيل، وهو ثمرة متابعة من الباحث استغرقت ثلاث سنوات تجاوز خلالها الرصد والتسجيل إلى تحليل الوقائع والتطورات المرتبطة بالصراع، المعلنة والمسكوت عنها، منذ عام 2020، وهو تاريخ توقيع الاتفاقيات المعروفة باسم الاتفاقيات الإبراهيمية التي أعقبت فشل "صفقة القرن" في تحقيق أهدافها. في حين أن تحيز المؤلف للحق الفلسطيني ودفاعه عنه، بحكم موقعه وانتمائه الوطني والفكري، وهو ميزة تحسب له بالتأكيد، إلا أنه اجتهد كي لا يقوده هذا الموقف المتحيز إلى إغفال تطورات أو تجاهل أسئلة أو التركيز على ما يوافق تحيزه، وانتهج في الكتاب منهج التحليل العلمي والنقدي، محاولاً استشراف المسارات المستقبلية المحتملة التي لا تتأثر بإيمان عميق مستمد من دراساته لحركات التحرر الوطني بالانتصار. كان المؤلف واعياً إلى الكثير الذي يتعين عمله حتى يتحقق هذا النصر الموعود، وبلور هذا الوعي في رده على المداخلات الصديق العزيز محمود عبد الحميد، الذي اختتم تعليقات الحضور، متسائلاً أين هو النصر الذي تتحدثون منذ عام 1948 وإلى اليوم؟ ومتى يتحقق؟ وماذا فعلنا من أجله؟
الوقائع والحقائق في مواجهة السرديات
المشكلة الأساسية في السرديات، خصوصاً السرديات الكبرى، هي أن السردية تحول، عادة، دون رؤية التغيرات وتأثيرها، بل تمنع، أحياناً، رؤية الواقع ومسارات تطوره الفعلية والمحتملة. هنا، تبرز أهمية استدعاء الوقائع والحقائق لتفكيك السردية ليس بقصد إعادة تركيبها أو ترتيبها، وإنما بقصد استكشاف مساحة تدخل الإرادات المتصارعة من أجل تحقيق التغيير المنشود. تجدر الإشارة هنا إلى أن السردية تختلف عن الايمان بعدالة القضية، وأن الإيمان بعدالة القضية أمر مختلف بدوره عن الإيمان بحتمية النصر، ولا ننكر هنا أهمية بل وضرورة الإيمان بحتمية النصر في مشروع المقاومة، ولكن لا ينبغي لمثل هذا الإيمان ان يمنع انتقاد حركات المقاومة، خصوصاً إذا كان لحركة المقاومة مسؤولية أخرى تتعلق بالإدارة والحكم خاضت في سبيل الحفاظ عليه صراع اقترب من أن يكون صراعاً مسلحاً، أو الدفاع عنها وتخوين الفصائل الأخرى التي قد يكون لها رؤية مختلفة، ودون الحرص على فهم منطق أصحاب الرؤى المختلفة بزعم أن لا مجال لوجهات النظر والرؤى في الصراع مع إسرائيل والعداء لها، والذي قد يدفع البعض إلى اعتبار أي نقد يوجه للمقاومة أو أي وجهة نظر أخرى مغايرة درب من دروب الخيانة والاستسلام، والمأساة تكون أكبر عندما تأتي مثل هذه الاتهامات من مراقبين يجلسون في مقاعد المتفرجين.
من هنا، تأتي أهمية الكتاب بفصوله الخمسة التي جرى ترتيبها ترتيباُ موضوعيا وزمنيا، يمكن من خلال تتبعه معرفة كيف تطورت الأحداث منذ طرح صفقة القرن لفرض حل للقضية الفلسطينية يقوم على فكرة الدولة الإسرائيلية الواحدة، الأمر الذي يعني عملياً تصفية القضية، وتمكين المشروع الإسرائيلي في المنطقة في مواجهة المشروع الإيراني أو المشروع التركي أو أي مشروعات إقليمية أخرى محتملة، وصولا إلى عملية طوفان الأقصى، الذي كان بمثابة رد من المقاومة على صفقة القرن وعلى الاتفاقيات الإبراهيمية التي قامت على أساس طرح نتنياهو الرافض لمبادلة السلام بالأرض، والمستند إلى حسابات وأولويات مختلفة للدول التي أبرمت تلك الاتفاقيات، وهي حسابات قصيرة النظر وتتجاهل كثيرا من الحقائق على الأرض، وفي مقدمتها الثمن الذي قد تدفعه هذه الدول نتيجة لدخولها في تحالف إقليمي يتصارع مع قوى إقليمية أخرى على رأسها إيران. ويُقدم هذا الكتاب، الذي مزج بين مقالات للمؤلف في صحيفة الأهرام ودراسات سابقة نشرت في عدة دوريات رصينة، تقييما نقديا لصفقة القرن والاتفاقيات الإبراهيمية في الفصل الأول، ومعالجة لمفهوم التحرر الذاتي والحركة الوطنية الفلسطينية خصص لها الفصل الثاني من الكتاب، الذي طرح فيه أفكارا تسعى إلى كسر الجمود الراهن في المشروع الوطني الفلسطيني وتجاوز تعثره، وخصص الفصل الثالث لرصد التطورات السياسية على الساحة الإسرائيلية وصعود اليمين المتطرف، وعالج في الفصل الرابع طوفان الأقصى وحرب الإبادة المستمرة التي تتعرض لها غزة وبدعم دولي للعدوان الإسرائيلي عليها، وبحث أفاق الدولة الفلسطينية في الوقت الراهن.
وأضاف المؤلف فصلاً خامساً بنصيحة من الناشر ولديه باع طويل في النضال لنصرة الحق الفلسطيني، تناول فيه أحلام اليمين الصهيوني في تغيير جغرافية الإقليم ونظر إليها من خلال معادلة القوة والحق. وأشار المؤلف أن الهدف الرئيسي من الكتاب ومن الدراسات والمقالات التي اشتمل عليها، هو إفادة الباحثين والمهتمين بالشأن الفلسطيني، خاصة الأجيال الجديدة المؤثرة والتي يتطلع إلى أن تكون قوة دافعة للقضية الفلسطينية ومساندة للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والكرامة. ولا يمكن لأحد أن يختلف مع هذا الهدف النبيل للكتاب ولكل جهد يبذل في سبيل تحقيقه، لكن من المؤكد أننا قد نختلف أو نتوافق بشأن السبل والأدوات والآليات لتحقيق ذلك. وربما كان حرص المؤلف على تأكيد أهمية المزاوجة بين الأدوات المختلفة من كفاح مسلح وحملات المقاطعة وبين العمل السياسي والدبلوماسي من أجل التغيير، وعلى الرغم من بديهية الأمر، إلا أن كثيراً من البديهيات تضيع وسط الشعارات، وقد يفصلنا الاستغراق في الأحلام والإيمان الذي يصل إلى حد اليقين عن رؤية الواقع وتلعب السردية دوراً كبيراً في ذلك.
والسردية هنا، ليست فقط سردية عربية وإسلامية وفلسطينية، فهناك أيضا سردية صهيونية، لكن من المهم ألا يشغلنا الصراع مع السردية الصهيونية عن رصد التحولات وحساب موازين القوى والعمل على وضع استراتيجيات للصراع وإدارته، في ظل تلك الموازين المختلة وصراع القيم. أذكر أن المؤلف حذر في ندوة عقدت في حزب التجمع بعد أشهر من بدء الحرب الأوكرانية من خطورة تأييد الموقف الروسي في غزوه أوكرانيا على الوضع الفلسطيني، ومن أن يستخدم هذا التأييد كمسوغ لتبرير العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، ففي الوقت الذي ننتقد فيه القوى الغربية بسبب ازدواجية المعايير، لا ينبغي أن نمارس مثل هذه الازدواجية في المعايير، فنؤيد تحت أي مبررات أو تحليلات أو تحالفات دولية غزو شعب آخر بالقوة المسلحة. بالتأكيد، لا يوجد عدوان في العالم مماثل في وحشيته للعدوان الإسرائيلي على غزة وعلى الفلسطينيين في الضفة الغربية وعلى الفلسطينيين الذي صمدوا على أرض في الحدود التي رسمت بموجب اتفاقيات الهدنة في عام 1949.
قد أتحفظ، هنا، على التمييز الذي أجراه الدكتور عبد العليم بين الفئات الثلاث للشعب الفلسطيني بين فلسطيني الشتات الذي هاجروا وأسسوا حياة جديدة لهم في المهجر، وبين الشعب الفلسطيني في الداخل الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، والشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال سواء في مخيمات اللاجئين أو في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة. فعلاوة على أن هناك عشرات المعايير التي يمكن أن نُميز على أساسها ما بين الفلسطينيين، إلا أنه ومن واقع خبرة واحتكاك بكل هذه الفئات المشار إليها، يمكن القول بدرجة كبيرة من الثقة أن الشعب الفلسطيني واحد وقضيته العادلة واحدة، والكل يعمل بطريقته من اجل دعم ومساندة الصمود الفلسطيني على الأرض في كل مكان، فهذا الصمود هو المقاومة الحقيقية للسردية الصهيونية والمخططات الرامية لاقتلاع الشعب من أرضه وتهجيره قسراً أو بتقديم إغراءات وتسهيلات، ولا ينبغي أن ننسى أن مشروع المقاومة الفلسطينية المسلحة نشأ في الشتات، وانتقل تدريجياً إلى الداخل بعد اجتياح لبنان في عام 1982.
لكن تحفظي على سردية اليسار والسردية القومية العربية، ومن قبلهما على السرديات الدينية المختلفة أكبر، وتحفظي على رفض أي انتقاد يمكن توجيهه للمقاومة وما قد ترتكبه من أخطاء تكتيكية أو استراتيجية أقوى وأشد، فبدون هذه الانتقادات لا يمكن أن نستوعب شيئاً من التاريخ ودروسه ولا يمكن لنا أن نقدم رؤية للمستقبل، أو ننتج خطاباُ بلغة يفهمها العالم، ومن المؤسف أننا من فرط عدائنا لما تمثله الصهيونية ومشروعها المتجسد في إسرائيل نعجز عن رؤية الانقسامات داخلها ناهيك عن استثمارها واستغلالها، بل نتبنى، دون أن نشعر، في السرديات الخاصة بنا خطابات ترسخ لسردية العدو ورؤيته. من المهم أن نشرع في تفكيك السرديات ونقدها بغرض تجاوز الوضع الراهن، وما يكشف عنه من تناقضات لا تعمل في صالح الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. قد نبدأ بتفكيك سردية اليسار، لكننا لن نقف عند هذا الحد.
سردية اليسار والصراع الحضاري
قد تبدو السردية الدينية أكثر تماسكاً وانسجاماً مع الصياغة التي تضع الصراع مع إسرائيل في إطار الصراع الحضاري بصيغته الدينية، والحقيقة أن مقولة إن الصراع مع إسرائيل هو صراع حضاري بالأساس هي الأساس الذي استندت إليه فكرة أن الصراع مع إسرائيل ومع الغرب هو صراع ديني. وفكرة الصراع الحضاري لا يطرحها فقط الإسلاميون والعرب، وإنما يطرحها أيضاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال في أكثر من مناسبة إن حكومته تشن حربا "من أجل الدفاع عن الحضارة" بالنيابة عن القوى الكبرى. الهدف من مثل هذا الخطاب هو كسب تأييد القوى الكبرى ودعمها له في الحرب على الفلسطينيين في غزة، وغض البصر عما يرتكبه من جرائم ضد الشعب الفلسطيني توصف بأنها جرائم إبادة. المشكلة الأساسية في سردية اليسار تتمثل في الإطار الذي تنظر من خلاله إلى الصراع، وتوزعها بين النظر إلى إسرائيل بوصفها قاعدة متقدمة للإمبريالية العالمية التي تتزعمها الولايات المتحدة، ومن ثم اعتبار أن الولايات المتحدة هي العدو الرئيسي للشعب الفلسطيني وللشعوب العربية، دون امتلاك تصور لكيفية إدارة الصراع معها الذي قد يتطلب تحييدها. قد تتناقض هذه الرؤية أحياناً مع الاعتقاد بأن الانحياز الأمريكي لإسرائيل والدعم المطلق لها راجع إلى قوة اللوبي الإسرائيلي أو اليهودي في الولايات المتحدة. لقد أشرت في أحد المقالات التي نشرتها عن أهمية تحليل التناقضات في ظل هذا الصراع للتمييز بين ما هو رئيسي وما هو ثانوي في هذه التناقضات الدولية والإقليمية.
أحد الإشكاليات الأساسية في رؤيتنا للصراع والمرتبط بالسردية القومية، وخصوصا سردية اليسار، مرتبط بتصورات سائدة عن حصاد حركات التحرر الوطني العربية، لاسيما حرب التحرير الجزائرية، أو الرجوع إلى خبرات تاريخية أقدم مثل الحروب الصليبية والتي أسست إمارات تابعة لها استمرت لعقود ولم يتم تدميرها إلا مع صعود القوة العسكرية لمصر المملوكية، الذي لم يصمد في مواجهة القوة العسكرية العثمانية. أزعم أننا لم ندرس تلك التجارب دراسة مدققة كي نصل إلى استنتاجات تعيننا على فهم ما حدث بالضبط وعلى التشابكات التي ترتبت على الصراع وتسويته. وكثيرا الاستشهاد بالتكلفة البشرية التي دفعها الجزائريون من أجل استقلالهم، وزاد تقدير عدد شهداء الثورة الجزائرية من مليون شهيد إلى مليون ونصف في مداخلات بعض أقطاب اليسار المشاركين في الندوة.
قد تكون أحد النتائج المهمة التي ترتبت على الحرب الأخيرة في غزة هو وضوح هذا الارتباط العضوي بين إسرائيل والولايات المتحدة، من خلال حملة المقاطعة الواسعة للمنتجات الأمريكية وللشركات الأمريكية والأوروبية الداعمة لإسرائيل، لكن يجب الانتباه إلى أن هذه المقاطعة ليست هي السلاح الرئيسي في المواجهة، خصوصاً في ظل اعتماد قطاعات واسعة من الجمهور العربي على الاقتصاد الأمريكي والاستثمارات الأمريكية المباشرة التي توفر فرص عمل، وقدرة المنتج الأمريكي على المنافسة أو لكونه منتجا وحيدا لا غنى عنه، مثلما هو الحال في صناعات أساسية مثل الدواء والإلكترونيات الدقيقة والمتقدمة بل والسلاح، أيضاً، ومثل هذا الوضع يجعل من الصعب بمكان وضع استراتيجية للمواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة إلا في حدود معينة، وتكشف تعقيدات العلاقات الأمريكية الإيرانية مدى صعوبة مثل هذه الاستراتيجية، وتطرح تساؤلات بشأن ما الذي يعنيه الاستقلال في ظل التشابكات والبنية المعقدة للاقتصاد السياسي العالمي، لسنا هنا في حاجة إلى خطاب جديد وإنما نحن في حاجة إلى رؤية جديدة تمكننا من تحويل ضعفنا إلى قوة قادرة على الصمود والمواجهة، وفي ظل الوضع الفريد للولايات المتحدة في الشؤون العالمية والذي يمنحها وضع الوسيط الذي يمتلك جانبا من أوراق الحل، على الأقل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وبعيداً عن أن مثل هذه الرؤية التي تنطلق منها السردية اليسارية والقومية تشكل أساساً لرواج نظريات المؤامرة وما يترتب على سيادة هذه النظريات من سلبيات خطيرة، أهمها التنحي عن تحمل مسؤوليتنا، كنخب وحكام بل وشعوب أيضاُ، عما نتعرض له، والتي تدفعنا الاعتقاد إلى حد الإيمان بحتمية نجاح المؤامرات التي تحاك ضدنا، خصوصاً في ظل تأميم السياسة وحرمان المجتمعات العربية من قدراتها التنظيمية من أجل إحكام السيطرة على مقدراتها وتهميشها وإضعافها ودفعها للجوء إلى ما يشبه بالحلول الانتحارية والاستهانة بالحياة، فإنها تحول أيضا دون التفكير بطريقة مختلفة في مسألة الصراع الحضاري. وبعيداً عن الطرح الإسلامي المهيمن على فكرة الصراع الحضاري، والموقف الذيلي الذي يتبناه اليسار رغم أن المنطلقات الفكرية التي يرتكز عليها بنت الفكر الإنساني العام، يمكن النظر إلى مسألة الصراع الحضاري على النحو الذي طرحه الأستاذ أحمد بهاء الدين في مقالاته، بعد هزيمة يونيو 1967، والذي طرحه قبله الأستاذ خالد محمد خالد في كتابه "من هنا نبدأ" الذي نشره بعد حرب عام 1948، وهي رؤية تركز على أهمية النهضة الداخلية كشرط لتحقيق النصر الموعود.
ربما كان غياب هذه الرؤية مسؤولاً إلى حد كبير عن غياب أي أفكار أو تصورات بخصوص المستقبل، وشكل الدولة التي يمكن أن تؤسس بعد تحقيق النصر على المشروع الصهيوني وموقفها من العالم، وتجاهل ما يصدر من خطابات داعمة للمقاومة تثير مخاوف الكثير من الشعوب والتي توظفها مراكز رصد ودوائر إعلامية وبحثية داعمة لإسرائيل لإثارة مخاوف الدول الغربية من مشروع المقاومة العربي، خصوصاً أن جانباً من هذه الخطابات كان مدعوما بأعمال عنف استهدفت المصالح الغربية. ومن المؤشرات التي تبعث على الأمل في إمكانية قيام حوار يفضي إلى إعادة صياغة الخطاب الداعم للمقاومة الفلسطينية ما طرحه الأستاذ علي عبد الحميد الناشر، وهو رئيس مركز الحضارة العربية، في مداخلته التي حاول أن يرسم فيها ملامح صورة الدولة الفلسطينية التي قد تنشأ بأنها دولة المواطنة التي تمنح حقوقا متساوية لسكانها. أيضا لا يمكن إغفال قضية الديمقراطية وغيابها، وهذا الإغفال وتأييد نظم استبدادية مثل النظام السوري بدعوى دعمه للمقاومة، هو أحد نقاط الضعف الرئيسية في السردية القومية واليسارية.
------------------------
بقلم: أشرف راضي